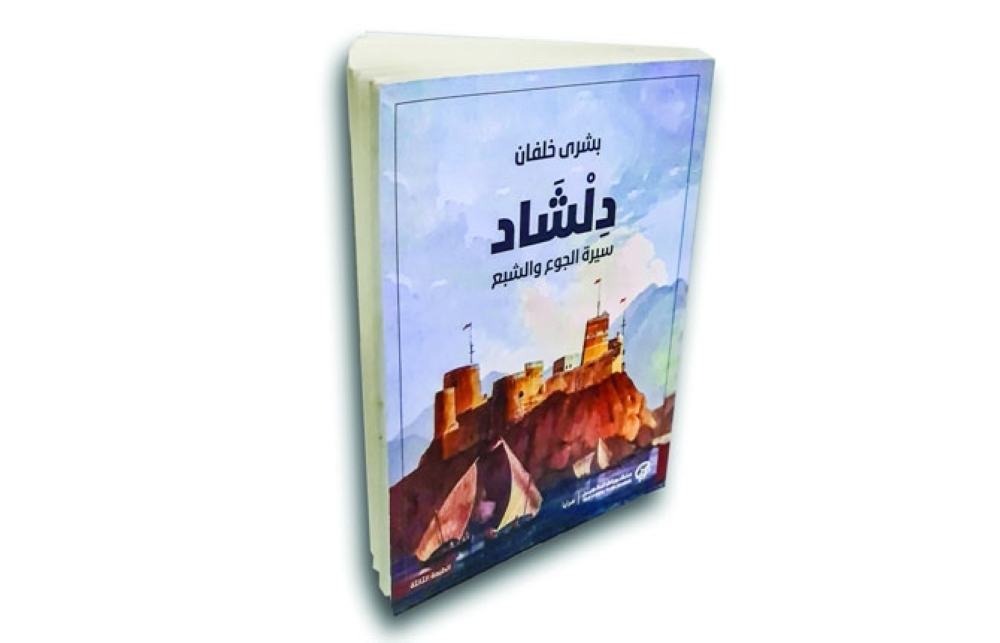كانت لنا أيام.. الأذان بصوت واحد: «أذوووون»

يرتبط شهر رمضان في طفولتي ليس بالصوم إنما بالأذان وكذلك بالدكاكين، بالنسبة للأذان فقد كنا نحن الأطفال قبل أن نصل إلى سن (التكليف) نكلف من أهالينا بأمور أخرى تتعلق بالصيام ومقتضياته، كنت أقضي طفولتي بين قرية سرور ومدينة مطرح، سرور قرية لديها عراقتها وتقاليدها، بينما مطرح -العريقة كذلك- في طور التمدن كعاصمة تجارية، وكان الزمن فترة السبعينيات.
في سرور مثلا كان لجدي ناصر بن عيسى -رحمه الله- مسجده «التبينيات» الذي بناه قبل ولادتنا بعقود، يجري من تحته فلج «بوجدي»، أمام هذا المسجد بنى الجد كذلك مجلس عام للقرية أو «مضافة» تعرش فوقها أشجار المانجو (تقريبا أربع أشجار سامقة)، وحين تكون مثمرة فإن أصوات سقوطها تسمع بدون انقطاع على سطح المجلس الذي كان سقفه هشا، يتحول إلى طبل على إيقاع توالي سقوط حبات المانجو الناضجة، حيث ستذهب خيالاتنا، فما أن ينشغل جدي حتى نتسلق إلى السطح، ونظل نأكل في أماكننا كل ما تطاله أيدينا من ثمرة المانجو الناضجة، أحيانا يطلب منا جدي أن نجمعها له، تغسل من الفلج وتقدم فوق صحن وتقشر لنأكلها وجبة جماعية، وكل من صادف وجوده من الأهالي أو العابرين لن يترك أن يمر قبل أن يشاركنا، ولكن في شهر رمضان وقبل الأذان، كانت أمهاتنا يطلبن منا التربص لسماع أذان المغرب، ونشر خبره في الأرجاء، فنشكل حلقة لعب تحت المسجد، ونتحول في لحظة الأذان إلى آذان مصغية، ثم إلى مكبر صوت طبيعي، حين ننطلق بحلق واحد الكلمة الممطوطة «أذوووون»، وهذا النداء سيستفيد منه كذلك مختلف الجيران الذين يكونون في تلك الساعة منتظرين على صحون الإفطار على أهبة الاستعداد، وفي تردد لن يحسم أمره بدون تدخلنا، كانت آذانهم إلينا نحن الذين استلمنا نداء التكبير من الجد، الذي شرع يكمل الأذان حتى نهايته، ولكن الباقي لم يكن يعنينا بعد أن التقطنا الكلمة الأولى، وشرعنا ننشرها بين مسامع الجالسين على صحونهم، نشعر بأهميتنا في تلك اللحظات، وكأنما قد بلغنا رسالة أمهاتنا على أكمل وجه.
قبل ذلك، كنا ننتظر بشغف أن تمر سيارة بيع الثلج التي تأتي عادة بعد العصر، تبيع الثلج كتلة واحدة عادة، مغلفة بورقة نايلون شفاف، تقوم بعد ذلك أمهاتنا بتكسيرها وتوزيعها على الأوعية الفخارية لتبريد ماء الشرب المجلوب فوق الرؤوس من «أم الفلج»، وإذا وجدت زجاجة «فيمتو» فإن ماء الآونة الفخارية يصير حلوا وأحمر وباردا أيضا، وقبل أن تظهر سيارة الثلج هذه، التي يصير وجودها مصيريا وسحريا لتحويل الماء الساخن إلى بارد في أيام الحر الشديد، كان أهلنا يرسلوننا إلى الدكان الوحيد في الحارة، وهو «دكان العمراني» لنشتري ما نقص في المطبخ، وعادة ما يكون حفنة من الطحين أوالسكر وكذلك بطاريات حجرية احتياطا قبل أن يخيم الظلام، إذ لم تدخل الكهرباء إلى قريتنا بعد، وحين جاءت الكهرباء بعد ذلك، استغنينا عن سيارة الثلج، وخلعت القرية رويدا رويدا رداءها القديم، وزاد عدد «الدكاكين» في قريتنا، أول ما فعله عمي يعقوب -رحمه الله- هو أن حقق حلمه القديم بشراء فيديو لمشاهدة فيلم «عنتر وعبلة» وقتما يشاء، وهو الفيلم الذي منى نفسه بمشاهدته، حين تفرج عليه أول مرة في سينما قرية «فنجاء» المتاخمة، وكان الفيلم من بطولة سراج منير وكوكا وإخراج نيازي مصطفى، ولكن الذي كتب الحوار الشاعر العبقري بيرم التونسي، لذلك فإن الكثير من الكلمات لا تلبث وأن تحفظ، ومن المشاهدة الثانية فقط، من قبيل عبارة «تمنى يا عنتر» التي كافأ بها شداد البطل عنترة اعترافا بإنجازه البطولي، لم يفارق ذلك الشريط فم جهاز الفيديو إطلاقا، بل ربما لم يعرف عمي يعقوب شريطا آخر بعده، حتى أننا حفظناه صورة صورة، ما أن ندخل إلى غرفته إلا ويشغل لنا شريط عنتر وعبلة، فنراه بنفس الحماس الذي رأيناه أول مرة، مع فرق مهم: هو أننا كنا نتحدث عن اللقطة الموالية قبل حدوثها، وهناك من يتفاجأ بأنها حدثت بالكمال والتمام.
حاليا تنتعش في جميع المناطق العربية والإسلامية (الدكاكين) في شهر رمضان، وخاصة في الأوقات القليلة ما قبل الإفطار، قد تتساءل أين كان هؤلاء البشر طوال اليوم، لماذا تختنق المحلات في هذه الدقائق أكثر من غيرها؟ وتتذكر دكان العمراني في طفولتك، الذي لم يكن يزوره سوى الأطفال، وكان ينتعش بالفرح حين يدخلونه على مجموعات يسبقهم الهرج والمرج، حيث كان يضع أمامه في الطاولة مباشرة العلب الأكثر تداولا وهي المليئة بالحلوى.
تنتشر كذلك في مسقط على سبيل المثال قبل الإفطار بساعة تقريبا محلات بيع المعجنات، وهي عادة صناعات محلية، حيث تتحول بعض الشوارع إلى مطابخ مفتوحة لقلي وبيع معجنات (السمبوسة، والبكورة، والمندازي، واللولاة، ولقيمات القاضي..
إلخ)، في المغرب مثلا في هذا الوقت -وخاصة في مدينة فاس- كان يطبخ في الشارع مباشرة (المسمن والبغرير والملاوي والحرشه).
تغلق الدكاكين أبوابها أثناء الإفطار، ولكنها ما تلبث أن تفتح بعد ذلك، وهذه المرة ستظل حتى ساعات متأخرة من الليل دون أن تغفل محلات (الشوارما) التي أصبحت علامة مميزة في مسقط بطابعها التركي، حين تقرأ لافتات محلات (الشوارما)، تشعر -لحظة- وكأنك في أحد شوارع إسطنبول، حيث لابد أن يكون ثمة كلمة تشير إلى الفضاء التركي البعيد حتى وإن كان الذي يبيع في المطعم من جنسيات أخرى.
في الحي الذي أسكن فيه بمسقط، هناك سبعة محلات (شوارما) كلها تحمل لافتات مكتوبة بالعربية والإنجليزية، ولكن لابد من وجود اسم تركيا أو إسطنبول على لافتاتها، ضمنها المطعم التركي الذي يعمل فيه شاب جزائري، ومعه شاهدت المباراتين الوديتين الأخيرتين اللتين لعبهما المنتخب المغربي، في إحداهما تفوق على المنتخب البرازيلي (اثنين مقابل واحد)، وكان الشاب الجزائري وهو ينتقل بخفة بين الزبائن يشجع بحماس المنتخب المغربي الذي يكن له الجميع إعجابا صادقا، بعد الأداء البطولي الذي قدمه في مونديال كأس العالم الأخير بدولة قطر..